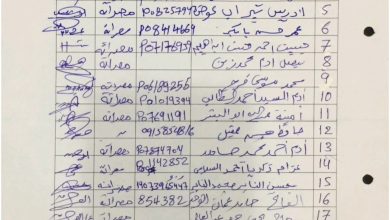ظاهرة “اللايفاتية”:الجمهور المتعطش لليقين
في مجتمع تهتز فيه أسس اليقين وتنهار مرجعياته تحت وطأة حرب مدمرة، ينشأ فراغ هائل لا تملؤه المؤسسات الرسمية الغائبة ولا النخب المنهارة. هذا الفراغ يستدعي ولادة “سلطات معرفية” بديلة، تتغذى على الارتباك الجماعي، وتفرض حضورها في الفضاء الرقمي.في هذا المشهد الدموي العبثي الذي صار عليه السودان ،يبرز على خشبة الفضاء”ممثلو الحقيقة”ليملؤوا الفراغ،هم ليسوا مفكرين ولا محللين، بل تجار أزمات محترفون،يقدمون مسرحًا يوميًا للطمأنة والصدمة معًا، يُسوّقون الأمل والخوف واليقين المؤقت كسلع، ويوزعونها على جمهور يبحث عن معنى وسط الخراب.حولوا قلق الناس الوجودي وخوفهم من المجهول إلى سلعة يومية رائجة.
حين ينهار الإطار المؤسسي، يصبح السعي إلى المكانة الرمزية، عبر امتلاك الخطاب وتوزيعه، هو العملة الأهم. فيتحول (اللايف) إلى طقس جماعي يُعيد إنتاج الوهم بالسيطرة والمعنى. بهذا المعنى، فإن (اللايفاتية) ليست مجرد محتوى عابر، بل شكل من أشكال السلطة الرمزية التي تنبني على هشاشة البنية الاجتماعية، وعلى عطش الجمهور لليقين في عالم فقد بوصلته.
الانصرافي ومحمد خليفة :
اسمان يترددان كأيقونتين لهذا العصر الرقمي المريض، يقدم كل منهما نفسه كمنقذ معرفي، بينما هما في جوهر الأمر لا يجسدان إلا العرض الأكثر فجاجة لانهيار المعايير:هوس الشهرة والرغبة العارمة،في تثبيت موقع داخل هرم المكانة: يظهران كنموذجين لدراسة ظاهرة تسميم العقول، ليس كغاية شخصية فحسب، بل كاستجابة لآليات نفسية واجتماعية عميقة.
كلاهما، يدّعيان امتلاك المعرفة الشاملة والقدرة على فك شفرات الواقع المعقد. إن جوهر الظاهرة لا يكمن في الأفراد وحدهم، بل في التفاعل الجدلي بين (المؤثر) و(الجمهور) فحين يغيب المرجع المؤسسي، وتنهار المصادر التقليدية، يصبح اللايف أو التقرير مساحةً للتعويض النفسي والاجتماعي: ساحة يبحث فيها المتحدث عن التقدير، ويبحث فيها المستمع عن الطمأنينة(عن التقدير والحب والاعتراف، وهي الدوافع الأساسية التي تحرك السعي البشري نحو الشهرة والمكان)،إنها مسرحية يومية لا تُعرض للترفيه، بل لتسكين القلق الوجودي، ولتوزيع جرعات من وهم المعرفة والسيطرة وسط واقع لا يرحم.
الجمهور لا يكتفي بالمشاهدة، بل يمنح هؤلاء المؤثرين سلطة الاعتراف،كإستجابة جماعية لأزمة أعمق،يحوّلهم إلى مرجعيات رمزية،علاقة تبادلية: المؤثر يسعى إلى تثبيت مكانته عبر ادعاء امتلاك التفسير الشامل، والجمهور يجد في هذا الادعاء بديلاً عن المؤسسات الغائبة.
صناعة الأوهام:الشهرة كعرض مرضي
تمثل ظاهرة “اللايفاتية” عرضاً مرضياً لمجتمع يعيش أزمة وجودية. ففي غياب الدولة والإعلام المهني، يصبح كل فرد مشروع “خبير استراتيجي”. إن السعي المحموم نحو “الشهرة” الرقمية ليس سوى تعويض عن فقدان المكانة في الواقع. ظاهرة الانصرافي وخليفة ليست مجرد قصة شخصين يبحثان عن الشهرة. إنها مرآة لمجتمع بأكمله يعاني من “القلق والخوف” على المستوى الوجودي. فالمواطن الذي فقد بيته وعمله وأمنه، فقد أيضاً مكانته في العالم. وحين يتابعهما، فهو لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن استعادة شعوره بالقيمة والأهمية، ولو بشكل رمزي، عبر الانتماء لخطاب “المنتصرين” أو “العارفين”.إن شهرتهما هي عرض مرضي لحالة القلق الجماعي التي أنتجتها الحرب.
لقد نجحا لأنهما قدما للناس ما يريدون سماعه بالضبط، لا ما يحتاجون إلى معرفته. قدما لهم اليقين في زمن الشك، والانتماء في زمن التشتت، والشعور بالسيطرة في زمن العجز. وهذه هي الوصفة المثالية لاكتساب المكانة والشهرة في أزمنة الانهيارات الكبرى.
يختلف الجمهور المستهدف لكل منهما:يتجه الانصرافي إلى الجمهور العريض، الذي أنهكه القلق ويبحث عن يقين مطلق وشعارات بسيطة وحاسمة (خير مطلق مقابل شر مطلق).
بينما يخاطب خليفة جمهوراً نوعياً، ربما أكثر تعليماً، يبحث عن تحليل “أعمق” وتفسيرات تربط الأحداث بسياقات سياسية، لكنه يظل جمهوراً يريد هذا التحليل في قالب جاهز وموجه يؤكد قناعاته المسبقة.
في النهاية، كلاهما يبيع سلعة واحدة: السيطرة المعرفية. الانصرافي يبيعها في شكل تعبئة وشحن معنوي مستمر، وخليفة يبيعها في شكل مرجعية فكرية وتحليلية يُفترض أنها وحيدة وموثوقة.
الأول يخلق حالة من الإدمان العاطفي على “اللايف”،
والثاني يخلق حالة من الإدمان الفكري على “التقرير”.
وفي الحالتين، يتحقق الهدف الأسمى: اكتساب المكانة والشهرة عبر تلبية أعمق احتياجات الجمهور في زمن الانهيار.
الانصرافي الغموض :صوت الغوغاء واليقين المبسط
الانصرافي نموذجاً فريداً في بناء الشهرة،في زمن الشك تكمن ظاهرة الانصرافي في غموضها.فالغموض يحرره من قيود الشخصنة، يمنحه هالة من القداسة والسلطة المعرفية؛شخصية مجهولة،تتحدث بلغة بسيطة ومباشرة، تخاطب وجدان المتلقي لا عقله.لا وجه لها سوى صورة رمزية، لا يمكن فهم ظاهرة الانصرافي إلا باعتبارها احتفاءً بالجهل المنظم.شهرته ليست إنجازاً، بل هي وصمة عار على جبين وعينا الجمعي. إنها دليل على مدى اليأس الذي وصل إليه الناس ،هو صوت بلا وجه، وهذا الغموض ليس تواضعاً، بل هو جبن مدروس وشرط أساسي لنجاح مشروعه. فمن لا وجه له لا يمكن محاسبته،لا يسعى للشهرة عبر إبراز ذاته، بل عبر إخفائها.
إن فهم ظاهرة الانصرافي يتطلب الغوص في مستنقع من التناقضات الصارخة، حيث لا توجد أي قيمة ثابتة، كرنفال من التلاعب، يبدأ أحياناً بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وفي أحيان أخرى ينطلق من صخب أغاني محمود عبد العزيز، رمز الحنين لدى أجيال، ليمرر من خلالها خطابه…لينتهي دائماً في مستنقع أغاني “الزنق” و”القونات” الهابطة. هذه الازدواجية ليست عفوية، بل هي استراتيجية شيطانية تهدف إلى أسر كل أنواع الجماهير.عندما يبدأ بآيات القرآن، فهو يخاطب الوازع الديني لدى قطاع من متابعيه، ويضفي على “اللايف” هالة من القداسة والشرعية الزائفة. إنه يغلف بضاعته السامة بغلاف مقدس، موحياً بأن حربه الكلامية هي “جهاد”، لكن هذه القدسية المزعومة سرعان ما تتبخر، حيث لا يتورع في نفس “اللايف” أو في “لايفات” أخرى عن سب الدين وشتم المقدسات بأقذع الألفاظ.تناقض فج يكشف عن حقيقة منهجه: الدين ليس قناعة، بل مجرد أداة وظيفية، تُستخدم عند الحاجة وتُداس بالأقدام عندما تتعارض مع نوبات غضبه أو متطلبات خطابه التعبوي.
وعندما لا يستخدم الدين، فإنه يمارس قرصنة على الوجدان الشعبي. يختطف الذاكرة العاطفية النبيلة المرتبطة بمحمود عبد العزيز وشعبيته،ثم يغرق وعي المتابع في ضجيج “الزنق”، ليخلق حالة من الهيجان والقبول اللاواعي. يتم استبعاد أي صوت معارض أو سؤال مزعج، ولا يُسمح إلا بالترديد والاحتفاء الجماعي.ظاهرة “القونات” كانت هي التدريب الثقافي والنفسي الذي هيأ جزءاً من المجتمع السوداني لتقبل ظاهرة “الانصرافي”. لقد حفرت “القونات” مجرى التفاهة ، ليأتي الانصرافي بعد ذلك ويملأ هذا المجرى بالبروباغندا السياسية العكرة.
عندما يبدأ “اللايف” الخاص به بأغاني الزنق والقونات، فهو لا يفعل ذلك عشوائياً. إنه يستدعي كل الإرث من السطحية والقبول باللامعنى.تجهيز العقل للتلقي السلبي: العقل الذي اعتاد على استهلاك أغاني الزنق، التي لا تتطلب أي مجهود فكري وتعتمد على الإثارة اللحظية، يصبح أكثر قابلية لاستهلاك خطاب سياسي بنفس المواصفات: شعارات بسيطة، إثارة عاطفية، وغياب تام للتحليل النقدي ،أو تدجينه بالدين، ثم يبدأ في ممارسة دور الغوغاء الرقمي.
في مواجهة حرب معقدة ومتشعبة، يقدم الانصرافي سردية شديدة التبسيط.لا أسئلة معقدة حول أسباب الحرب أو المسؤوليات المشتركة. هذا اليقين القاطع هو ما يطلبه جمهوره الذي يعيش حالة من القلق الوجودي والخوف الدائم. فالمعلومة هنا ليست أداة للفهم، بل هي “جرعة” من الطمأنينة والأمل بالنصر الحتمي.
شخصية نجحت في تحويل القلق الفردي إلى مشروع جماعي،فمتابعوه لا يبحثون عن تحليل سياسي رصين بقدر ما يبحثون عن أمل ضائع في خضم حرب كارثية،يمزج بين لغة الشارع والخطاب التعبوي.
صوت الغضب يستثير الأعصاب هذا الأسلوب: يمنح متابعيه شعوراً بالقوة والفاعلية في عالم يشعرون فيه بالعجز في زمن الشدة،تحليلات مبسطة، و قاطعة، و”توجيهات” واضحة. هو لا يفسر الحرب بقدر ما “يؤطرها” ضمن النصر، بهدم أي رواية مضادة، وتفكيك أي محاولة لتقديم قراءة مركبة للصراع.
يستخدم الانصرافي لغة الشارع، بمصطلحاتها البسيطة والمباشرة “هذه اللغة تخلق رابطاً عاطفياً فورياً مع المتلقي، وتؤسس لنوع من “العصبية” الرقمية.
من يتابع الانصرافي ويستخدم مصطلحاته يصبح جزءاً من “جماعة العارفين”، جماعة تمتلك شفرة خاصة لفهم ما يجري، مما يمنح أفرادها شعوراً بالتميز والانتماء في زمن التشتت..إن شهرة الانصرافي هي نتاج مباشر لنجاحه في تحويل قلق متابعيه من الحرب إلى ولاء مطلق لشخصه (أو فكرته). هو لا يبيعهم تحليلاً، بل يبيعهم انتماءً ويقيناً، مصاغة بلهجة الواثق.، حيث أصبحوا مستعدين لتعليق عقولهم على أبواب “لايفاته”، مقابل جرعة يومية من وهم النصر وقصص البطولة الكاذبة.
محمد خليفة: شبه المثقف الوصي وسلطة التقرير
على نقيض “الانصرافي” الذي يمثل الوجه الشعبوي الفوضوي، يسلك محمد خليفة مسارًا مختلفًا في سعيه نحو الشهرة. فهو يقدّم نفسه بصفة “الباحث” و”المثقف” الذي يمتلك الأدوات التحليلية لكشف ما يُخفيه الآخرون. لا يخفي هويته، بل يستخدمها كجزء من بناء صورته كشخصية مطلعة وذات خلفية وسياسية.
ويصوغ لقبه “خال الغلابة”، كمزيج ذكي بين السلطة الرمزية (“الخال” كشخصية حكيمة في الثقافة السودانية) وبين التعاطف الشعبي (“الغلابة).
خلف هذه الصورة يقف ما يمكن تسميته أزمة التحليل النخبوي. خليفة ليس استثناءً، بل هو انعكاس لوعي ثوري لم ينضج. إنه وعي هتافي، تجمد في لحظة المراهقة السياسية لثورة ديسمبر، حيث كان الهتاف والفعل العاطفي هما رأس المال الرمزي. غير أن هذه اللحظة البطولية لم تتحول إلى وعي نقدي قادر على مواجهة تعقيدات الدولة والمجتمع. وهكذا، ظل خليفة أسيرًا لذهنية المتاريس، يستبدل التحليل بالهتاف، ويعيد إنتاج وصاية “المثقف” الذي يحدد للآخرين ما يجب أن يؤمنوا به وما يجب أن يرددوه،يتجلى في رغبته في أن يُنظر إليه كـ”المثقف الوصي” على الثورة والحرب.
فهو لا يقدم للغلابة أدوات الوعي لكي يفهموا، بل يقدم لهم “الهتاف” الصحيح الذي يجب أن يرددوه.إن مأساته هي مأساة جزء كبير من جيل الثورة الذي احتفى بـ”الفعل” على حساب “الفكر”.يعتمد أسلوبه على التقارير المطولة، المليئة بالمصطلحات السياسية واللغة الأكاديمية، ليصنع لنفسه هالة من الجدية.
يجذب جمهورًا يبحث عن تفسير للواقع، لكن يريده تفسيرًا جاهزًا، قوته تكمن في الإيحاء بأنه مطلع على الكواليس، قريب من دوائر القرار،فهو لا يتردد في تقديم “أخبار” تبدو وكأنها تسريبات من أعلى المستويات، كما فعل حين ساق خبراً مفاده أن المملكة العربية السعودية اتخذت قراراً ما بناءً على توصية مباشرة من البرهان، مقدماً المعلومة بثقة تجعل القارئ يظن أنه يقف على اعتاب الديوان الملكي و غرفة العمليات العسكرية.
من خلال تقاريره، لا يصف الواقع فقط، بل “ينتجه”؛ فهو يحدد ما هو مهم وما هو هامشي، من هم الفاعلون الحقيقيون ومن هم مجرد أدوات.يضع فيها نفسه في موقع الشاهد والحكم. يظهر في استعراضه المستمر لمصادره، أسلوبه، الذي يجمع بين السرد القصصي والتحليل السياسي، يهدف إلى إقناع القارئ ليس فقط بصحة معلوماته، بل بشرعية موقعه كـ”محلل استراتيجي”.يحول التسريب المزعوم إلى حقيقة دامغة.
إن سجالاته مع منتقديه ليست مجرد نقاش، بل ممارسة للسلطة عبر النص. فالتقرير ليس أداة للمعرفة، بل أداة لفرض الوصاية، وترسيخ صورة الكاتب كمرجع لا يُمس. بذلك، يتحول المشروع برمته إلى نرجسية فكرية تتغذى على الحاجة إلى الاعتراف، وإلى سعي محموم لاحتكار الحقيقة، ممارسة لـ”الأنا” المتضخمة التي تدّعي الاطلاع على الكواليس كـ”وصي” على وعي “الغلابة” الذين لا حول لهم ولا قوة بدونه.تمامًا كما يفعل “الانصرافي”، وإن اختلفت الأدوات.
المحصلة أن محمد خليفة لا يقدم وعيًا بقدر ما يعيد إنتاج مأزق جيله: خيانة الثورة بتحويلها من مشروع تحرر إلى مجرد حالة عاطفية معلّقة.
في زمن الحرب، ارتدى خطاب “المحلل الاستراتيجي”، لكنه ظل يستخدم أدوات المراهقة الثورية القديمة: الهتاف في ثوب التقرير.
اليقين ضرورة للبقاء:مساران لنفس الغاية
لا يمكن فهم ظاهرة “اللايفاتية” دون تحليل الطرف الثالث في المعادلة: الجمهور. لماذا ينجذب مئات الآلاف إلى هذه الخطابات؟ الإجابة تكمن في أن حياتهم أصبحت تعتمد بشكل مباشر على ما يجري.
الحرب لم تعد خبراً يُقرأ في صحيفة، بل هي واقع دموي يهدد وجودهم اليومي. في هذا السياق، يصبح البحث عن المعلومة ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة للبقاء.
هنا يبرز “الطلب” الذي يخلق “العرض”،الجمهور لا يريد تحليلاً معقداً يغوص في جذور الأزمة، بل يريد أن يعرف: هل منطقتي آمنة غداً؟ هل هناك هجوم وشيك؟ متى ستنتهي هذه المأساة؟ الانصرافي وخليفة وأمثالهما يقدمون إجابات مباشرة وحاسمة لهذه الأسئلة الوجودية. يقدمون “ما يريد الجمهور أن يسمعه”: ان الوضع غارق في الفوضى فاهربوا.وسيهاجمون المنطقة الفلانية والوضع غير مبشر…أو أن هناك من يسيطر على الموقف، وأن هناك خطة، وأن النصر قريب.هذا التعلق باليقين، حتى لو كان زائفاً، هو آلية دفاع نفسي ضد الصدمة والقلق المستمرين اللذين تخلفهما الحرب.
لقد أدت الحرب إلى ارتفاع هائل في معدلات الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة. في ظل هذا الانهيار النفسي، يصبح خطاب اليقين بمثابة “مسكن” للألم الوجودي، جرعة يومية من الأمل تساعد الناس على الصمود ليوم آخر.
تحليل مقارن لمنهجيات الشهرةعلى الرغم من أن كلاً من الانصرافي ومحمد خليفة يسعيان إلى تحقيق هدف واحد، وهو ترسيخ نفسيهما كمرجعيات أساسية في زمن الحرب، إلا أنهما يسلكان مسارين مختلفين تماماً في أسلوبهما ومنهجيتهما لبناء هذه المكانة، يمثلان قطبين متمايزين في سوق “اليقين” الرقمي.
الانصرافي يبني سلطته على الغموض، بينما يبنيها خليفة على الظهور.
يستمد الانصرافي قوته من كونه صوتاً بلا وجه، “فكرة” لا يمكن محاصرتها أو مساءلتها شخصياً، مما يمنح “صرفته” (معلومته الحصرية) هالة من القداسة وكأنها وحي مُسرّب لا يقبل النقاش.
في المقابل، يضع خليفة هويته كـ”باحث” في صلب مشروعه؛ فسلطته تأتي من شخصه المعلن وخبرته المفترضة، ويقدم “الحقيقة” لا كمعلومة خام، بل كـ”استنتاج” تحليلي رصين لا يمكن دحضه بسهولة.
تتجلى هذه الثنائية في المنصة واللغة. يختار الانصرافي البث المباشر العفوي على فيسبوك، مستخدماً لغة شعبية وعاطفية تخاطب الوجدان مباشرة، وتصنع “جماعة” متماسكة عبر مصطلحات مشتركة.
أما خليفة، فيلجأ إلى سلطة النص المكتوب، عبر تقارير مطولة ومنشورات تحليلية تستخدم لغة تبدو أكاديمية وموضوعية، بهدف ترسيخ صورته كـ”المثقف الوصي” أو الخبير الاستراتيجي.وبالتالي، يختلف الجمهور المستهدف لكل منهما.
يتجه الانصرافي إلى الجمهور العريض، الذي أنهكه القلق ويبحث عن يقين مطلق وشعارات بسيطة وحاسمة (خير مطلق مقابل شر مطلق).بينما يخاطب خليفة جمهوراً نوعياً، ربما أكثر تعليماً،وثوريًا أو شبه ثوري يبحث عن تحليل “عميق” وتفسيرات تربط الأحداث بسياقات سياسية، لكنه يظل جمهوراً يريد هذا التحليل في قالب جاهز وموجه يؤكد قناعاته المسبقة.
في النهاية،ليسا سوى وجهين لعملة زائفة واحدة، كلاهما يبيع سلعة واحدة: السيطرة المعرفية.
الانصرافي يبيعها في شكل تعبئة وشحن معنوي مستمر، وخليفة يبيعها في شكل مرجعية فكرية وتحليلية يُفترض أنها وحيدة وموثوقة.
الأول يخلق حالة من الإدمان العاطفي على “اللايف”،
والثاني يخلق حالة من الإدمان الفكري على “التقرير”.
وفي الحالتين، يتحقق الهدف الأسمى: اكتساب المكانة والشهرة عبر تلبية أعمق احتياجات الجمهور في زمن الانهيار، استغلوا قدسية اللحظة المأساوية التي تمر بها البلاد،في تحويل قلق الناس المشروع إلى رأسمال لشهرتهما الشخصية، وبنيا مكانتهما على جماجم الضحايا وعذابات الملايين.
مؤثرو الحرب: وباء عالمي
ليس القصد بأي حال من الأحوال الدعوة إلى إسكات أي صوت، أو سلب أي فرد حقه في التعبير وتوثيق ما يراه حقيقة. ففي زمن الحرب، يصبح كل توثيق، مهما كان بسيطاً، فعلاً مقاوماً ضد النسيان. هذا النقد لا يستهدف (فعل) التوثيق أو (حق) التعبير، بل يستهدف (منهج) التضليل و(صناعة) الوهم التي تتخفى خلف ستار هذين الحقين.إنه نقد لاذع ليس للأشخاص في ذواتهم، بل للظواهر الخطيرة التي يمثلونها، وللدور الذي يلعبونه، في تسميم الفضاء العام.
إن ظاهرة الانصرافي وخليفة هي ليست مجرد شذوذ سوداني.بل نسخة محلية من وباء عالمي اسمه (مؤثرو الحرب)،لم يعد حضور الحرب مقصورًا على الجبهات والخرائط العسكرية؛ لقد تمدد إلى الفضاء الرقمي حيث يتنافس الأفراد لا على السلاح فحسب بل على امتلاك السردية،حيث يتحول إلى ساحة صراع لا تقل ضراوة عن ساحات القتال،يزدهر حيثما اجتمع السلاح مع الإنترنت المتاح للجميع. لكل نسخة من هذا الوباء خصائصها التي تجعلها أكثر فتكاً في بيئتها.
في سوريا:
رأينا (المراسل المواطن) الذي بدأ كشاهد عيان شجاع يوثق جرائم النظام، ما لا يصل عبر الإعلام الرسمي. لكن مع الوقت، سرعان ما تحول في كثير من الحالات إلى بوق دعائي لفصيل مسلح، حيث أصبح ولاؤه يلون عدسة كاميرته، فتحول من شاهد إلى مشارك في التضليل، فلم يعد التوثيق بريئًا، بل انحيازًا وصراعًا على الشرعية.
إن البحث عن المصداقية هناك كان أيضًا بحثًا عن الاعتراف والاعتلاء في سلم المكانة داخل جماعاتهم.
في أوكرانيا،مع الغزو الروسي:
تجلّت الظاهرة بشكل آخر،شهدنا موجة من (المؤثرين) على منصات مثل تيك توك وإنستغرام،مقاطع قصيرة، موسيقى مؤثرة تحت القصف، وصور مصقولة لعرض جوانب من الحياة تحت الحرب.
لم يكن الهدف مجرد توثيق المعاناة ، بل استجداء تعاطف الجمهور الغربي،كانت حرباً تخاض بالجماليات البصرية السريعة، حيث تم تبسيط السردية لتناسب عقلية الاستهلاك الرقمي، ارتبط بالقدرة على مخاطبة الآخر الخارجي، انتزاع عطفه،وحشد الدعم الدولي،وكسب تعاطفه،ومواجهة الدعاية الروسية،وتأكيد أن الحرب ليست مجرد مأساة محلية بل قضية كونية تستحق الالتفات.
-أما النسخة السودانية، فهي الأكثر ماساًة،تأخذ الظاهرة مسارًا مختلفًا،لا يُوجَّه الخطاب أساسًا إلى الخارج، بل إلى الداخل.هدفهما ليس كسب التعاطف الدولي،بقدر ما هو السيطرة الكاملة على العقل المحلية وتشكيل الرأي العام الداخلي.
بينما اعتمدت الظواهر في سوريا وأوكرانيا بشكل كبير على الصورة والفيديو لتوثيق الحدث،تعتمد الظاهرة السودانية بشكل أكبر على (الكلمة) سواء كانت منطوقة في (لايف) أو مكتوبة في(تقرير).
هذا يعكس الطبيعة الأكثر تعقيداً واستقطاباً للصراع السوداني، حيث يتحول المؤثر إلى مفسر، واللايف أو التقرير إلى محاولة لاحتكار الكلمة، وتثبيت موقع ضمن هرم المكانة الرمزية في مجتمع ممزق.
إن (مؤثري الحرب)في كل مكان هم انعكاس لطموح الإنسان إلى الظهور والاعتراف حتى وسط الخراب.
غير أن الشكل الذي تتخذه هذه الظاهرة محكوم بسياقها: من التوثيق في سوريا، إلى التسويق في أوكرانيا، إلى التفسير في السودان. وفي كل الأحوال، الحرب لا تُدار بالسلاح وحده، بل بالكلمة التي تحدد من هو الضحية ومن هو البطل، ومن يملك الحق في الصعود إلى منصة الاعتراف.
والأخطر من ذلك، أن سلاحهما ليس “الصورة” كما في سوريا وأوكرانيا، بل “الكلمة”.سواء كانت منطوقة في هذيان “لايف” أو مكتوبة في غطرسة “تقرير”، فهي أداة أكثر مرونة لخلق الأوهام وبناء الحقائق الموازية.هذا التحول من الصورة إلى الكلمة يعكس الطبيعة المتعفنة للصراع السوداني نفسه؛ لم يعد صراعاً على الأرض فقط، بل أصبح صراعاً وجودياً على “التفسير” و”المعنى”. وفي هذا الصراع، يصبح تجار الكلمات، أمثال الانصرافي وخليفة، هم أخطر أنواع تجار الحرب.